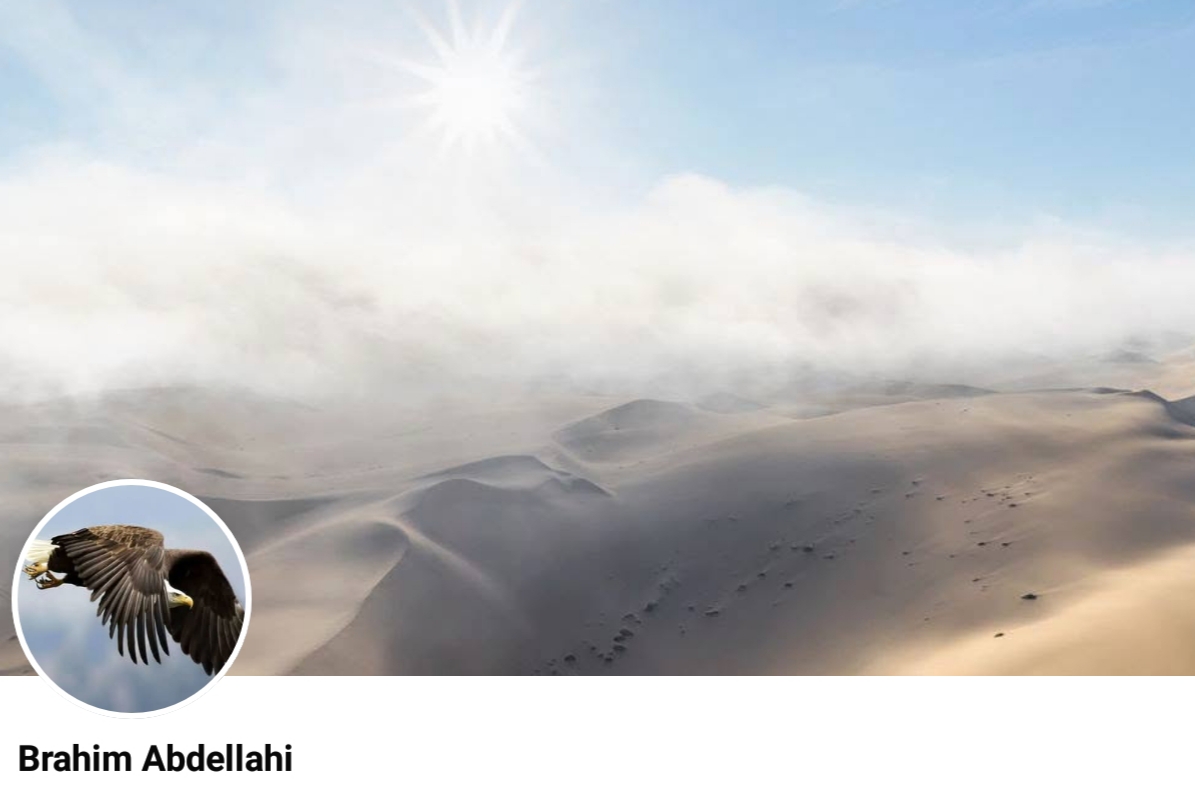
بنشاب : حين تشتدُّ عُقدُ الأزمنة، وتتقاطعُ مسالكُ الذاكرة مع دهاليزِ النسيان، يغدو الصمتُ خيانةً، وتصبحُ الشهادةُ فريضةً أخلاقية لا ينهضُ بها إلا من تحرّر من أهواء اللحظة، وارتفع عن ضجيج المناكفات، واستمسك بميزان العدل المجرّد. وفي مثل هذه اللحظات المفصلية، لا يُستدعى القولُ للزينة، ولا تُستحضر البلاغةُ للتكلف، بل يُستنهض اللسانُ ليكون أمينًا على الوقائع، حارسًا للمنجز، وشاهدَ صدقٍ على ما كان، لا على ما يُراد له أن يُمحى أو يُحرّف.
إنّ الحديث عن فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليس استدعاءً لاسمٍ في سجلّ الحكّام، ولا اجترارًا لخطابٍ مألوف، بل هو وقوفٌ عند مرحلةٍ كثيفة الدلالة، متشابكة الأثر، انطبعت في جسد الدولة ووجدان الأمة معًا. مرحلةٌ خرجت فيها الدولة من طور الهشاشة إلى مقام الهيبة، ومن ارتباك البدايات إلى صرامة البناء، ومن تردّد القرار إلى حسم الإرادة.
لقد كانت سنوات قيادته امتحانًا عسيرًا لفكرة الدولة ذاتها؛ دولة القانون لا دولة الأشخاص، دولة المؤسسات لا دولة المزاج. فشهدت البلاد خلالها تشييدَ بنىً لم تكن جدرانًا صمّاء، بل أعصابًا حية في جسد الوطن: طرقٌ شقّت الصمت، منشآتٌ رفعت سقف السيادة، ومرافقُ أسست لمعنى الخدمة العمومية بعد أن كان الحلم بها مؤجّلًا. ولم يكن العمران غايةً في ذاته، بل وسيلةً لإعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها؛ علاقة تُقاس بالمنجز لا بالوعود، وبالفعل لا بالخطابة.
أما في السياسة، فقد جرى الانتقال من منطق الإقصاء إلى أفق التعدد، ومن الخوف من الاختلاف إلى إدارة الاختلاف، في زمنٍ إقليميٍّ مضطربٍ كانت فيه الفتن أسرعَ من الريح، والانقلاباتُ أسبقَ من الرأي. ومع ذلك، ظلّ الاستقرار عنوانًا عريضًا، لا صدفةً ولا هبةً، بل ثمرةَ قبضةٍ واعية تعرف متى تشتد ومتى تلين، ومتى تُقدِم ومتى تُحجِم.
ثم كان الختام، وهو أعسرُ الفصول وأصدقُها امتحانًا: احترام الدستور، وتسليم الأمانة في لحظةٍ كانت شهوةُ البقاء فيها أقربَ من حكمة الرحيل. فكان العبورُ الآمنُ إلى ضفة التداول، شاهدًا لا يُدحض على أن الدولة، حين تُبنى على قواعد، لا تنهار بتغيّر الرجال، بل يزداد رسوخُها.
غير أنّ التاريخ، وهو يُنصف في المدى البعيد، يبتلي في المدى القريب بنكوصِ الوفاء، ونكرانِ العشرة، وتقليبِ الحقائق حتى تبدو المآثرُ مثالب، والإنجازاتُ تُهَمًا. وهنا تتجلّى مرارةُ الخيانة، لا بوصفها موقفًا سياسيًّا، بل سقوطًا أخلاقيًّا، إذ لا شيء أفدح من أن يُجحد المعروف، ويُنكَر الجميل، ويُرمى الأمسُ بالحجارة بعد أن كان مهدًا وملاذًا.
ولا خيرَ في خِلٍّ يخونُ خليلهُ
ويلقاهُ من بعدِ المودّةِ بالجفا
وينكرُ عيشًا قد تقادمَ عهدُهُ
ويُظهرُ سرًّا كان بالأمسِ قد خفا
سلامٌ على الدنيا إذا لم يكن بها
صديقٌ صدوقٌ صادقُ الوعدِ مُنصفا
أبياتٌ تختصر فلسفةَ الوفاء، وتفضحُ خواءَ من يبدّل مواقفه كما تُبدّل الأقنعة، فإذا المصالحُ ميزانُه، وإذا الأمسُ عبءٌ يتخلّص منه لا تاريخٌ يصونه.
إنّ شهادةَ الحق لا تُكتب بالحبر وحده، بل تُنقش في الضمير، وتُسلَّم للتاريخ لا ليحاكم بها الأشخاص، بل ليهتدي بها اللاحقون. ومن هذا المنطلق، فإن الإنصاف يقتضي أن يُقال: لقد كانت تلك المرحلةُ لبنةً كبرى في صرح الدولة، ونقلةً نوعية في مسار الاستقرار، وعهدًا شهد بناءَ مؤسساتٍ وصناعةَ رجال.
وإذا كان الزمانُ دوّارًا، فإن الذاكرةَ الوطنية لا تنسى، والتاريخَ، مهما أُثقل بالغبار، لا يضلّ طريقه طويلًا. فشكرًا لمن بنى الدولة وصنع الرجال، وشكرًا لمن سلّم الأمانة غير مُكرهٍ ولا مُلتوٍ، وليبقَ الوفاءُ هو الامتحانَ الأصعب، والميزانَ الأعدل، في زمنٍ قلّ فيه الصادقون.



(2).JPG)





